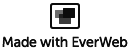ILA MAGAZINE
شعرية الفضاء وانزياحاته في رواية " الشطار" لمحمد شكري
د.خديجة البوعزاوي
يعتبر مفهوم الفضاء من المفاهيم النقدية الحديثة، التي حازت اهتمام كثير من النقاد والدارسين الغربيين، قبل أن ينتقل، عبر وسيط الترجمة، إلى حقل الدراسات النقدية العربية المعاصرة. حيث توسل إليه كثير من النقاد العرب في مقاربتهم للنصوص الإبداعية، في أفق الكشف عن ديناميته إن في إغناء المعنى أو في تفكيك مضمرات الخطاب.
لذلك، سنسعى في هذه الورقة إلى تجريب بعض ما توصلت إليه اجتهادات الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة – في ارتباط بمفهوم " الفضاء " – عبر مقاربتنا لرواية " الشطار " للروائي المغربي محمد شكري، الذي راهن، في بناء عوالم هذا العمل السردي، على إعطاء امتدادات مجتهدة وطموحة لمفهوم " المكان"، الذي تبين لنا، أنه يتخذ، في أحايين كثيرة، أبعادا تخييلية ورمزية، مما يجعل ديناميته تؤشر على مستوى آخر أعم، وأعمق وأشمل.
تنبغي الإشارة، في البداية، إلى أن ما يميز هذا العمل الروائي، كونه يستحضر مدينة طنجة، كفضاء – فضاءات، في سياق تسلسل الحكي وتدرجه، وفق تقنية الاسترجاع ( Flash – back ) الذهنية، بما هي تذكر لأحداث وقعت في الماضي، أو أشخاص عاشوا في فترات سابقة. كما أن هذا " الفضاء " قد تحول، داخل العمل، من مجرد دال عن المكان كجغرافيا، إلى معادل أكثر انزياحا وشساعة ودينامية، بحيث يطال الذاكرة والجوانب الحسية والمتخيل على حد سواء، بما جعل منه – عطفا على ذلك – مفهوما يختزل حيوات البشر ومصائرهم وأحاسيسهم الفردية والجماعية، أي تحول إلى فضاء تخييلي رمزي، تجاوز الواقع، ولم يكتف بتصويره فقط. نحن، إذن، أمام " فضاءات طنجية " متعددة - إذا ما صحت هذه التوليفة اللغوية - وليس فضاء واحدا فحسب. لذلك، ارتأينا أن نركز، في هذا المقترح القرائي، على فضاءين اثنين فقط من بين كل
الأفضية التي يزخر بها هذا العمل السردي، هما:
1– طنجــة فضاء البحث عن الذات،
2 – طنجة بحضورها كفضاء للخيبة واللعنة.
على الرغم من كون مدينة طنجة قد خضعت، كغيرها من المدن المغربية، لعوامل التغير السريعة، ولدينامية الحياة الهادرة والمتقلبة، إلا أنها ظلت – مع ذلك – تشد بإغرائها أرواح كل من شربوا من مائها أو عاشوا في منازلها المقابلة للجنوب الأوروبي، أو المفتوحة على الأندلس، ذلك الفردوس المفقود. ومن ذلك أنها ظلت تحتفظ بما يشبه السر المكنون، الذي جعل منها مثالا لتلك الذاكرة المفقودة - المستعادة، أو بالأحرى ذلك الفضاء الذي يستمد فتنته من ماضيها البعيد أو القريب – على حد سواء - الذي لا زال يلجم طموح الحالمين بمخاصمتها أو مغادرتها نحو وجهة أخرى بديلة.
وكمثال على هذه الجاذبية الآسرة، التي ظلت تختزلها المدينة عبر السنين، تحوُّلُها إلى ما يشبه الأيقونة التي كانت تهيمن على وجدان الكاتب محمد شكري، كما باتت تشكل لغزا تأسست عليه عوالمه السردية، إلى حدٍّ كان لا يغادرها إلا سهواً ليعود إليها وقد تملكه شوق عارم إلى أمكنتها العزيزة على نفسه، إلى أناسها الهامشيين، وإلى لياليها الحالمة. ولعل هذه العلاقة الغامضة هي ما جعل محمد شكري يصبح كاتب طنجة الكبير، الذي تميز عن كل مجايليه من الكتاب المغاربة، بكونه أحيا، في وقتنا المعاصر، تلك الصفة المغرية التي كانت لطنجة في الماضي القريب، باعتبارها مدينة كُوسْمُوبُولِيتِية تغري كتاب وفناني وموسيقيي العالم من الحالمين، الباحثين عن طمأنينتهم المفتقدة.
ومن الحكايات الطريفة التي كانت تحدث له، ارتباطا بهذا العشق الغامض ل " طنجته " (كما كان يفضل تسميتها)، أنه كلما كان يتلقى دعوة للمشاركة في بعض الأنشطة الثقافية، التي كانت تنظم في هذه المدينة المغربية أو تلك، غالبا ما كان يستقل القطار، وسيلته المحببة في السفر، وبمجرد ما يصل إلى مدينة أصيلة، أقرب محطة إلى طنجة، كان يغادر القطار عائدا إلى بيته، إلى ليل طنجة وإلى حبل سرتها الأثير، الذي جعل منه سمكة طنجة البرية. أليس هو القائل " القطار يقترب من المحطة. هنا أصيلة هنا ننزل. وداعا الرباط. ليست هذه أول مرة أفعل فيها هذه النزوة الجميلة ".
الأكيد أن هناك شيئا سحريا وغامضا، وجده شكري في طنجة ولم يجده في أي مكان آخر غيرها، شيء جعله لا يقوى على فراقها أو الغياب عنها ولو لفترة زمنية قصيرة، شيء جعل إمكانية استبدال فضاءات طنجة بفضاءات مدينة أخرى، خاصة في أعماله السردية، يقع - على الأقل في تقديره الخاص - في خانة الأمور المستحيلة. فكيف لا وهذه الأيقونة الشمالية تجعل كل من زارها يقع في حبها من أول نظرة، أجنبيا كان أو مغربيا، فما بالك بمن خبر حياة العَوَزِ والحاجة في أزقتها، قبل أن تشهد ولادتَه الثقافية القيصرية المغايرة.
1 ــ طنجة فضاء البحث عن الذات:
لا شك أن لفضاء طنجة سحرا خاصا يجعلها تحظى بطابع مميز لدى مجموعة كبيرة من الروائيين، لدرجة أصبح معها هذا الفضاء خليقا - دون غيره - ببناء علاقات عشقية بين الشخصيات التي يختارها كل روائي لعمله الإبداعي، كما شكل فضاء للبحث عن الذات.
وعلى الرغم من أن محمد شكري سبق له أن ألمح، غير ما مرة، إلى ما قد يعتبر خيبة أمل بالنسبة للذين يأتون إليها وفي تقديرهم أنهم سيعثرون فيها على نفس نمط الحياة التي عاشها الذين من قبلهم، إلا أن ذلك لا يمنع هؤلاء – مع ذلك – من محاولة اكتشاف ما كانت تزخر به من حياة هانئة سابقة، وما كانت تمنحه لعشاقها من إمكانات إعادة ترتيب أوراقهم المبعثرة. فما يهم هؤلاء، في تقدير شكري دائما، هو أن يعيشوا ولو على ذكرى ما تبقى فيها من آثار السابقين.
ولعل هذا الإحساس بالاحتواء، الذي تسبغه طنجة على وجدان ساكنتها وعلى زائريها، والذي يغمر النفس والروح بالاطمئنان بل بالتماهي مع فضاءاتها السحرية، ما نجد له أثرا بليغا في بعض المشاهد من رواية " الشطار "، حين يقوم الكاتب بنقل مشاعر أهاليها وهم يعبَرون عما يشدهم إلى حبل سرتها الآسر. ومن ذلك ما ينقله على لسان السارد بعد وصوله إلى سوق الكبيبات.
فبعدما يقوم بالسؤال عن قهوة السي عبد الله، ويطلب شايا بالنعناع، يأخذ له مكانا بجانب أشخاص يلتفون حول طاولة كبيرة وهم يلعبون الورق، ويدخنون الكيف، والبؤس باد على سحناتهم، لينخرط، بعد ذلك، في مشاركتهم السمر. حيث يقول: "في الليل غلبني الكيف، والجوع، والغربة. رشفت من كؤوس شاي بعضهم ورشفوا من كأسي. أحسست بالألفة بينهم. حدثتهم عن تطوان وطنجة ووهران، وحدثوني عن العرائش. قال أحدهم:
- كيقولو طنجة اللي ما شافهاشي كتبكي عليه، واللي شافها كيبكي عليها.
- إنها عريقة تهزم كل من يعشقها.
- العهر الفاحش قَبَّح أجمل ما فيها.
- لكنها جميلة وتاريخها عريق".
وفي حوار داخلي للسارد، يعكس نوعا من القدر المحتوم في ارتباطه، روحيا ووجدانيا، بالمدينة، وهو يتأمل حاضرها الذي شهد استحداث حانات جديدة تفتقد إلى روح وحرارة الحانات القديمة، يخيل إليه أن ذلك الليل الذي ألفه فيها سينمحي ويغيب بظهور البنايات الجديدة والحانات الممسوخة. فيتولد لديه الخوف من الإحساس بالاغتراب داخل طنجة التي عشقها ولم يستطع الابتعاد عنها.
إلا أن هذا الإحساس الضاغط بالاغتراب وضياع الوجهة والاستعداد لهجرانها، سرعان ما يبدده السارد باعترافاته التي تعيد التأكيد على تجذره في تربة المدينة واقتران مصيره بليلها؛ ليله الخاص، لا ليل الآخرين الذين لم يتوحدوا مع روحها. ومن ذلك قوله: "أكتب هذه المذكرات في حانة جديدة ممسوخة. إنها من الحانات الجديدة التي أقحمت في المدينة. هل جاء ليل وداعك يا طنحة؟ أبدا لا. إن ليل طنجة هو ليلي. لا يودعها من عاش فيها حتى تأذن له سرتها. كم عدت إليها مهما كان تناسلها وما أكثر ما سافرت وعدت من نصف طريقي إليها. الحقيقة هي المستقبل. لا أحد شاهد على ما أقول. إني وحيد ليلي. لا أحد يغزو وحدتي".
2 ـــ طنجة فضاء الخيبة واللعنة:
نفس النغمة المتشائمة، لكن هذه المرة بإيقاع مغاير، نترصدها في حديث محمد شكري في "الشطار"، حين يصل بين عالمين مختلفين، بل متعارضين: عالم النساء والجنس والمتع، من جهة، ثم عالم المقابر والأموات والخلاص من جهة ثانية، كأنما ليؤشر على نوع من الفرار من هذا العالم، عالم الليل غير الصادق والمُفْتَقِد للسلم والطمأنينة، مقابل عالم الأموات المسالم، الذي يوفر فسحة استسلام حقيقية للنوم العميق. هذا الإحساس بالسّكينة في عالم المقبرة يذهب به السارد إلى حد ربطه بحب دفين، أي حب الموت.
ولعل ذلك ما يبدو واضحا من قوله: "طنجة: ذكريات الأفخاذ، والربوات الجميلة، والصدور الناهدة، فأستمني. إن هذا المزيج من الذكريات المنثالة، يسلمني إلى غفوة أتجول بين ممرات قبورها. أجد إمتاعا، في محاولة قراءتها ولا أفهمها. لا أعرف ما يحفزني دائما إلى التجول في المقابر؟ أهو سلامها أم هي عادتي أيام نومي فيها؟ أم حبا في الموت؟".
لكن هذا النفور وهذا الخوف من لعنة طنجة ومن جحيمها، لا يفتأ أن يختفي أمام حجم ونوع المتع والأفراح والإغراءات، التي تقدمها لأبنائها، ممن طوحت بهم الأقدار خارجها؛ إنه نوع من الحب القاسي، الذي كلما ذقنا مراراته ومرارة الابتعاد عنه، كلما اشتقنا إليه أكثر. فها هو شكري، وهو نزيل مدينة العرائش، يقوم بتذكرها بألم شديد وبحزن واضح، على الرغم من الويلات والظروف السيئة التي لقيها بين ظهرانيها. إذ يقول: "اشتياقي إلى لعينتي طنجة يحزنني. لها عندي طعم مغر حتى في أحقر ظروفي فيها مهانة. لا أكاد أغادرها سَئِماً منها حتى يُوتِرُني حنين جنوني بها كما كنت في وهران أشتاق إلى تطوان".
هذا الحنين الجارف ل" طنجته " يتأكد من كلامه، مرة أخرى، وهو يصف لحظة اجتيازه لامتحان التخرج من معهد تكوين المعلمين في مدينة العرائش، حيث كان أول شيء قام به هو الاستنجاد بأحد أصدقائه الذي وفر له تذكرة العودة سريعا إلى طنجة، تلك " اللعينة" التي لا يستطيع عليها ابتعادا، مهما جفا أحدهما عن الآخر.
وفي ذلك يقول: "بعض رموز العالم بدأتُ أجد لها معانٍ فيما أقرأه، نجحت في امتحان الالتحاق بالتعليم الثانوي. نقلتُ من تلميذ في مادة الحساب. قيل لي إن بعضهم نجح بالرشوة أو الوساطة. قلت لنفسي: أنا أيضا غششت في مادة الحساب. ساعدني المطعمي السلهامي على شراء تذكرة السفر وعدت إلى طنجة: "لعينتي"، مهما جفا كلانا من الآخر".
وفي الليل؛ ليل طنجة، التي عاد إليها من العرائش، يستسلم شكري المفلس لأقدارها المفاجئة، بما قد تجود عليه به، مثلما على غيره، من متع تحملها المصادفات فقط. إذ يقول:
"يجاورني هينينج سكرام. كلانا يترك بابه منفرجا: أنا أنتظر حظي في امرأة، وهو في رجل. إنها الرغبة المفاجئة التي قد يجود بها، على أحدنا، ليل الممر. إنه الليل: ليل طنجة".
إلا أنّ مفاجآت طنجة وكرمها لا يأتيان، في كلّ مرّة، بما تشتهيه نفوس قاصديها - نساء ورجالا - ليس فقط من الباحثين عن المتع الرخيصة الواقعة في متناول الرّغبات والأهواء، وإنما أيضا ممن يطمحون إلى بناء أمجادهم الفنية والأدبية الإبداعية. بلْ يحدث أن تكون لعنتها أكثر وبالا على طموحاتهم وعلى رغباتهم، التي تنكسر على صخرها الصلد، من سخائها الزّئبقيّ المنفلت.
ولعل هذا الأمر هو ما سيؤكد، مرة أخرى، طبيعة المدينة المخاتلة، العصية على الترويض أو النفاذ إلى سرها المكنون، رغم كونها تقدم نفسها على أنها حلم من لا حلم له، وأنها العارية، الرنانة، الشفافة ... الأسطورة. إنها، في كلمة واحدة، تستطيع أن تسحق كل من لم يقدر سحر مائها. حيث يكون مصيره الضياع في دوامة حاناتها ومواخيرها الكاسرة. يقول شكري عن هذا الأمر: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تجيء فيها سالية إلى طنجة من مدينتها الصغيرة. تجيء زائرة، لكنها هذه المرة، تريد أن تُقيم. طنجة الحلم، طنجة العارية، الرنانة، الشفافة مثل كأس من البلور، طنجة الأسطورة، والجبل لكل صوت، لكن سالية لا تعرف أن طنجة تسحق من لا يعرف كيف يشرب خمرها المسحور. إنها مثل كيركا الساحرة. عرفت من جاءها ليكتب الشعر فلم يتعلم حتى لغة الحانات، ومن جاء ليرسم فلم يعرف حتى كيف يمزج الألوان. جاءت سالية هذه المرة من مدينتها لتخسر كل شيء من أجل أن تكسب كل شيء. إنها تراهن بأسفلها على أعلاها الهش ".
نفس الحقيقة يكررها شكري في مقطع آخر من " الشطار "، حين يصف طبيعة المتاهة التي أصبحت تعيشها " سالية "، التي باتت مقيمة في ليل طويل، داعر، ملعون وقبيح، هو ليل طنجة، بينما تجهد النفس في العثور عمن ينتشلها من هذا المستنقع، الذي تنكسر على صخره الأحلام، أحلام المتشابهات. حتى الشعر والشعراء والحالمون يتكبدون نفس الخسارة، في مدينة تمشي فيها الهزيمة مزهوةً مُخاتِلةً وفي منتهى الوضوح، كما أنها تستوطن كل الأمكنة.
ففي وصفه لهذه الحالة الميؤوس منها، حالة " سالية " وغيرها من المنتحرين في ليل طنجة، يرد على لسان شكري قوله: "لم يعد لسالية رائحة النهار. كل ليل لا نهار له. يُقَبِّحُها النهار ويُجَمِّلُها الليل. لم يعد يَهُمُّها إلا أن تعيش حتى تعثر على من يهواها وتهواه، لكن العشق في طنجة ليس من أحلام العذارى. إنها، هنا، فقدت نفسها لتصير مثل الأخريات ".
قبل أن يضيف في نفس السياق: " إنه زمن الشعر، وزمن الحلم في طنجة، لكن أين الشعراء، وأين الحالمون؟ إن الهزيمة تمشي في منتهى بؤس عرائها أينما شئت ".
لكن لعنة طنجة تصبح، على لسان شكري، بمثابة مأواه الأخير المحتوم، الذي سيقبل عليه إذا لم يحالفه الحظ في إتمام دراسته في العرائش. حيث يعرف، مسبقا، ما سيكون عليه مصيره، في نهاية الأمر، إنها نهاية داعرة عنوانها البؤس والفناء في عوالم القوادة أو اللصوصية أو الإجرام. وفي ذلك يقول: " لقد قَبِل مدير المعهد تسجيلي مستمعا. إذا سقطتُ فسأعود إلى طنجة لأصير أكبر قواد أو لص أو مجرم".
وفي حوار دار بين السارد وصديقه " حميد"، وبعدما أبدى الأول رغبته في العودة إلى القسم الداخلي تجنبا لتسجيل غيابه، في حين كان يطلب منه حميد الجلوس رفقته في انتظار عودة "عائشة" و"سعيدة" لتمضية الليلة بمعيتهما، أبدى شكري موافقته بما يؤكد استعداده لكل العواقب والمغامرات، مادام سيجد ضالته في طنجة الملعونة. حيث كان جوابه كالآتي:
"طز في الغيابات إذن. كسب العيش ينتظرنا دائما في طنجة".
هذا الأمر يتأكد بعد الاختبار الذي أجرته لجنة في ثانوية مولاي عبد الله بالعرائش لشكري - السارد، والذي كانت نتيجته إيقافه عن الاستمرار في الدراسة، إلى جانب تلاميذ آخرين، لكبر سنهم، ليقرر، بعدها مباشرة، العودة إلى طنجة.
إلا أن هذه العودة المكرهة جعلته يستشعر ذلك التحول والتغير الواضحين والمفاجئين في ليل طنجة. لقد انقضى زمن وحل محله آخر. لقد ذهب ليل طنجة السهل، الذي كانت تؤثثه عوالم بسيطة وفي متناول اليد. ذهبت نساء الأمس اللواتي أصابهن الهرم، بل نمت لبعضهن شوارب وظهر عليهن الإيمان. في المقابل، جددت المدينة دماءها، وبناءها ومتعها. حيث تبدو سطوة هذه الحقيقة المرة في نفس السارد مما جاء واضحا في كلامه المحبط، حين يقول:
"انتهى في طنجة زمن الدعارة الجميل. المواخير الخاضعة للرقابة الطبية منعت منذ سنوات. دورٌ سرية وفنادق حقيرة حلت محلها لتمارس فيها المحترفات الهرمات مهنتهن مع الوافدين من البادية، بحثا عن عمل، وفقراء المدينة، بأبخس الأثمان، بعضهن تُبْنَ، إنقاذا لكرامة شيخوختهن ودينهن، فصرن يعملن في المطاعم، والفنادق، ومنازل مُحْدَثِي النعمة. لقد نَمَتْ لبعضهن شوارب خفيفة، أو زغيبات متفرقة خشنة وتساقطت أسنانهن. قليلات هن اللواتي اغتنين بدعارتهن فاشترين دورا وأراضي أيام عودة الأجانب فتقاعدن في نعمة. والأخريات، الأكثر شبابا وجمالا، هاجرن إلى اسبانيا، فرنسا...وفي أواخر الستينات كان جيل جديد من المحترفات الشابات، المتحررات في لباسهن، وتعابيرهن، وأوضاعهن الجنسية، قد اكتمل نمو أجسادهن واستوى. غزين المدينة مثل الجراد، جئن من كل المدن. إنه جيل الفنادق الفخمة، والعلب الليلية، والمخدرات، وأهل التدعر مع أهل البلد والأجانب".
هذا الحنين الجارف دفع السارد إلى تقمص لغة ودور الشاعر، بعدما أحس، ربما، بأن لغة الحكي البسيط والمبا شر لن تسعفه في نقل مواجعه وآلامه وآهاته الكاسرة. ومن ذلك هذه القصيدة التي عنونها ب "طنجيس "، في إحالة على زمن بعيد ولى، زمن يمتح من ماء الخرافة والأسطورة ومحكيات العابرين. ومما جاء فيها:
" يحكون عنك: أن طينة الخلاص منك
وأن نوحا فيك قد تفيأ الأمان،
وأنه حمامة، أو هدهد،
وبين موجتين
تناسلت طنجة ملء زبد البحر
***
تعاقبت على بكارتك
مباضع الشبق والغزاة
مناسك الحلول والتناسخ
وان عيد باخوس
يفجر الجنون في الأصلاب،
والهذيان في ثغاء البحر،
كأنما طروادة يرثها الحصان،
كأنها في موتها عروس
أججها خامدة زيوس ".
هكذا، إذن، تتمظهر طنجة في هذا المبحث؛ باعتبارها فضاء ينكأ الجراح ويقلب المواجع، فضاء يذكر الهاربين من آلامهم وذكرياتهم السيئة بما هربوا منه، ليجدوه شاخصا أمامهم، ماثلا في الفضاءات كما على وجوه العابرين. إنها، بذلك، مدينة حمالة أوجه ومشاعر متضاربة، فقد تتحول، في لحظة سحرية خاطفة، إلى ساحة تتضاعف فيها حدة القلق وتتناسل فيها مسببات الحيرة، وتتوسع فيها هوة انشطار الذات في علاقتها بأسئلتها الوجودية وهويتها الخاصة..
ربما كان محمد شكري وهو يكتب " الشطار "، قد حدس طبيعة وهول تلك التحولات الجذرية التي كانت تعيشها " طنجته "، والتي تشبه ستارا هائلا وقاتما كان ينزل على خشبتها ليحجب تاريخا وعادات ونمط حياة، كانت جميعها تميز المدينة، كما كانت عنوان خصوصيتها الأبرز بين كل مدن المتوسط المنذورة للمتع والخلاص من جحيم العالم. لتحل محلها عادات بشعة وسيئة، أتت على كثير من معالمها الخاصة. وبذلك يكون هذا العمل السردي الهائل شهادة حية تعكس تحول مدينة طنجة من ملجأ للبحث عن الذات، إلى لعنة تتناسل بسببها مشاعر الخيبة واللعنة والانحسار،
التي تضاعف من عزلة الكائن وتُكَلِّسُ مشاعره الجَسُورة.
كاتبة و أكاديمية من المغرب